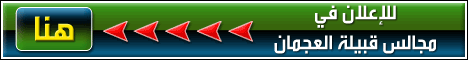د. إيمان عز(*)
مقدمة:
تهدف التربية بمعناها العام للوصول بالإنسان إلى حد الكمال في كل مجال من المجالات التي ينطوي عليها، سواء في الذكاء أو القدرات العقلية أو الشخصية.. إلخ، وإذا كان تحقيق هذا الهدف مستحيلاً، لعدم تحديد معيار الكمال ودرجاته، فإن الهدف الأكثر خصوصية والممكن تحقيقه هو مساعدة الإنسان على تنمية شخصيته وعناصرها إلى الحد الذي يسمح به نضجه الجسدي واستعداداته الفيزيولوجية التي نشأ عليها. من ذلك فمن المتوقع لعملية التربية ألا تكون سهلةً، بل لا بد من التسليم بأنها وسيلة معقدة تدخل في استخدامها وإعدادها جهات متعددة تبدأ بالأسرة الصغيرة وتنتهي بالمجتمع.
والعملية التربوية في أساسها عملية أخلاقية لأنها تتعامل مع الإنسان ككل - جسداً وروحاً ونفساً - بحيث تضمن له أفضل استثمار لقدراته وإمكاناته إلى الحد الذي يشعره هو والمحيطين به بالرضى والسعادة؛ لذا ليس من المستغرب أن أطلق (جون ديوي) مقولته: (إن عملية التربية والأخلاق شيء واحد، ما دامت الثانية لا تخرج عن كونها انتقال الخبرة باستمرار من أمر سيء إلى آخر أحسن منه)، وهو ما يجعل النمو الأخلاقي الهدف الأسمى للعملية التربوية والمدرسية كلها.
تؤكد النظريات التربوية والنفسية المعاصرة على النزعة الفردية الذاتية لدى الناشئة أكثر مما تؤكد على النزعة الغيرية، وهي بذلك -تقريباً- تنحّي جانباً مهماً من جوانب الإنسان، والمتمثل في الأخلاق، باعتباره يمثل الأنا الأعلى أو الضمير الذي يحكم كل سلوك يقوم به ويضبطه.
ويبدو أن تنحّي الأخلاق ودورها في تنمية المجتمع الإنساني ككل في هذه النظريات إنما يعكس جوانب ذاتية في شخصية المنظرين أنفسهم، كما تعكس البيئات التي عاشوا فيها، والتي حكمتهم بمعاييرها ومحكّاتها المختلفة التي تؤكد النزعة للتملك وللمكاسب المادية والمصالح أياً كانت الطريقة المتبعة في ذلك، وفي ضوء مقولة (الغاية تبرر الوسيلة).
لذلك فإن التربية الأخلاقية تبدو عملية صعبة شاقة تتطلب منظرين أكفاء ومنفذين قادرين على غرسها في نفوس النشء، متجاوزين عناصر الذاتية ودوافع التملك والسيطرة وتعارض المصالح.
إن مراجعة يسيرة للأسس التربوية السائدة في معظم دولنا العربية والإسلامية تبين ميلنا لتقليد ومحاكاة معايير المجتمعات الأخرى الأقوى صناعة وتقدماً، والأكثر سيطرة على العالم، متناسين غياب المعايير الأخلاقية فيها أو على الأقل ندرة الاعتماد عليها، ومتناسين أن هذه الأسس التربوية تتفق وطبيعة هذه المجتمعات ولكنها لا تتفق كثيراً مع طبيعة مجتمعاتنا وما يحث عليه الدين الإسلامي الحنيف من التوازن بين الذاتية والغيرية انطلاقاً من مبدأ (لا ضرر ولا ضرار).
ولا شك أن هذا يعني بشكل أو بآخر أننا كمنظرين تربويين ونفسيين عرب ومسلمين تناط بنا مهمة وضع أسس تربوية خاصة بنا تعتمد من ناحية على تراثنا الثري في هذا الميدان وتستند من ناحية أخرى على الاستفادة مما هو جارٍ في عالمنا المعاصر، على أن نأخذ منه السمين ونترك الغث الذي لا يتفق ومعاييرنا الإسلامية والعربية، منطلقين من فكرة علم نفس عربي وإسلامي أو علم تربية عربي وإسلامي بالمعنى الذي يرتبط بأسسنا الدينية المسلم بها، وليس بالمعنى المرتبط بالتفرد والتميز بعيداً عن علم النفس الإنساني ككل.
ويمكن القول بأن تحقيقنا لهذه المهمة وتنفيذنا لها إنما يتطلب منا الوقوف على بعض المسائل المتعارف عليها في التربية وعلم النفس والكامنة وراء ظهور سلوك الأفراد، ومنها نذكر:
الأخلاق بين الوراثة والبيئة
كثيراً ما طرحت أسئلة حول موروثية الأخلاق واكتسابها، وكثيراً ما أتت الإجابات مؤيدة لهذا الجانب أو ذاك، دون أن تصل إلى حد يفصل في ذلك، إلا أن واقع الحال يبين أن الأخلاق عملية مكتسبة أكثر منها موروثة؛ فهي لا تنتقل من الآباء إلى الأبناء كما تنتقل الصفات الجسمية؛ فالطفل يولد في أساسه على الفطرة، وهذه الفطرة فطرة خيرة سليمة تميل نحو الدعة ومكارم الأخلاق، أكثر منها فطرة شريرة، وإن كان يبدو أن الجانبين موجودان معاً، حسبما ذكر الله جل جلاله: (ونفس وما سواها * فألهمها فجورها وتقواها * قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها)(الشمس: 7-10)، إذ يندر لطفل ينشأ في وسط تربوي سيء أن يبقى ذا أخلاق حسنة، كذلك يندر أن يغدو ذا أخلاق ذميمة إذا نشأ في جو تربوي طيب يعبق بمكارم الأخلاق.
ومع ذلك لا يمكن أن ينكر دور العوامل البيولوجية تماماً، إذ يمكن أن تورث استعداداً لأن يكون الفرد على خلق معين لتأتي التربية فتنميه أو تنحيه، وهذا يعني أن الأخلاق لا تُورث، بل تُورث تركيبة عصبية فيزيولوجية معينة قابلة للمطاوعة والتأثر إيجاباً وسلباً.
اكتساب الأخلاق
من ذلك يبدو أن تعليم الأخلاق يبدأ في مرحلة الطفولة ويرتبط تماماً بأساليب التنشئة الاجتماعية، وما يرافقها من تقنيات وأساليب يتعرض لها الطفل أثناء قيامه بسلوكيات مرغوبة أو غير مرغوبة. إنه بلا شك يكتسب الضمير أو الأنا الأعلى الذي يتحلى به الآباء، ومعاييرهم في الحكم على الصواب والخطأ؛ لذا لا يكون من المستغرب اختلاف المعايير الأخلاقية وشدتها من أسرة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر.
والسؤال المهم يبقى عن الطريقة التي يتعلم بها الطفل الضمير أو الأخلاق من خلال عملية التنشئة الاجتماعية؟ كما تبقى الإجابة عن هذا السؤال محصورة في اتباع عدة أساليب مستقلة ومتتابعة ومتداخلة في آن واحد، دون الاعتماد على أسلوب وترك غيره؛ لأن التكامل فيما بينها قائم أساساً، بل لأن أحدها قد يؤدي إلى الآخر.
ونذكر من هذه الأساليب:
أ) الثواب والعقاب:
تعد أساليب الثواب والعقاب وسيلة هامة يلجأ إليها الآباء والمربون لغرس الضمير أو الأنا الأعلى في نفوس أبنائهم، إنهم يدربونهم عن طريق مكافأة وتدعيم استجابات معينة وإيقاع العقاب على استجابات أخرى، معتمدين في ذلك مبادئ نظرية التعلم التي تؤكد أن السلوك الذي يكافأ يميل لأن يقوى ويتكرر إلى الحد الذي يصبح فيه أسلوب حياة يلجأ إليه الفرد وكعادة سلوكية ثابتة نسبياً، وبالمقابل فإن السلوك الذي يُعاقب عليه يميل لأن يضعف وينطفئ.
وفي حال الأخلاق فإن الثواب والعقاب لا يبقيان خارجيين موجهين من قبل الأفراد المحيطين بالطفل، بل يندمجان ليشكلا جزءاً من الضمير أو الأنا الأعلى لدى الفرد بحيث يصبحان رمزيين أكثر منهما ماديين ملموسين، فقيام الفرد بسلوك يتفق مع معاييره ومعايير الجماعة يشعره بالسعادة والرضى، وهذا بحد ذاته نوع من المكافأة أو الثواب الذاتي، في حين أن قيامه بسلوك لا يتفق مع معاييره التي تربى عليها والمستدمجة فيه، يشعره بالذنب وبتبكيت الضمير، وهذا نوع من العقاب الذاتي، فبقدر ما تكون شدة المكافأة أو العقاب الذاتيين بقدر ما يجعلان الفرد ميالاً لإعادة السلوك وتكراره أو الابتعاد عنه وإطفائه.
ب) الملاحظة والتقليد:
يمكن للأطفال عن طريق ملاحظتهم لسلوك الآخرين، تنمية معايير أخلاقية وأنماط سلوكية محددة، فبمجرد ملاحظتهم لما يقوم به الآخرون فإنهم يتخذونهم قدوة، دون أي حاجة لتدعيم السلوك إيجابياً أو تنحيته سلبياً، وهؤلاء الآخرون يكونون عادة الآباء والمدرسين والأخوة والشخصيات المشهورة في المجتمع الحالي أو عبر التاريخ في أي مجال يقدره الطفل أو من حوله.
ترتبط ملاحظة الطفل لسلوك الآخرين بقدرته على تقليدهم ومحاولة محاكاتهم بدءاً من بداية السنة الثانية، حيث تعتمد المحاكاة على الملاحظة المباشرة للسلوك وليس على صورة ذهنية له، ولكنه لا يلبث أن يتحول تقليده من الصور المادية إلى الصور الذهنية حيث تستدمج هذه الصور داخلياً ويصبح قادراً على استرجاعها فيما بعد.
من المؤكد أن الطفل لا يقلد جميع سلوكيات الأبوين - أو القدوة - لأنه لو فعل ذلك لأصبح صورة طبق الأصل عنهما، إنه يقلد بعضها ويترك بعضها الآخر، مستنداً إلى أسلوب الثواب والعقاب، وما يترتب على السلوك المقلد من نتائج ممتعة له أو غير ذلك.
ولكن لا بد من الإشارة إلى أن الأمر لا يستند فقط إلى نتائج الثواب والعقاب، فالمحاكاة آلية أولية يلجأ إليها الطفل باعتباره كائناً ذاتي الإرادة؛ لأنه هو الذي يختار السلوك الذي يقلده حسب رغبته هو، وليس حسب اختيار الآخرين ورغبتهم فقط؛ مما يعطي مؤشراً على استقلالية إرادة الطفل حتى في موضوع المحاكاة والتقليد؛ مما يجعل السلوك المقلد مستدمجاً داخلياً ليصبح فيما بعد لا شعورياً.
ج) التوحد:
لا يقف ظهور السلوك عند حد الملاحظة والمحاكاة بل يتعداه إلى التوحد الذي يمثل أعلى مرحلة من مراحل التقليد؛ فالطفل يلاحظ وجود شخص يشبهه ثم لا يلبث أن يشاركه في كل سلوكياته، بل يبدو وكأنه يتقاسمها معه انفعالياً ووجدانياً؛ فيتبنى الطفل نمطاً كلياً ثابتاً نسبياً للسلوك الصادر عن الشخص المتوحد به والذي غالباً ما يكون الوالدين أو أحدهما.
يؤكد الثبات النسبي للنمط السلوكي أن السلوك الأخلاقي السائد في الأسرة هو ذاته السلوك الذي يتوحد به الطفل، وهذا ما يؤكد الموروثية الاجتماعية أو الأسرية للسلوك بشكل يصبح تعديله عسيراً، عكس السلوك الذي يعتمد على ملاحظة الآخرين.
في ضوء ما سبق يمكن القول بأن الطفل من خلال عملية التنشئة الاجتماعية يبدأ بالشعور بالقلق إذا لم يطبق المعايير الاجتماعية المقبولة على سلوكه الخاص، إنه يبني منظومة سلوكية ذاتية لا شعورية توجه سلوكه باتجاه ما بعيداً عن رقابة الشخص المتوحد به أو الرقابة الخارجية، إنه يعمل الآن برقابة داخلية نسميها الأنا الأعلى أو الضمير الخلقي.
نمو الضمير أو الأنا الأعلى
تبدأ مؤشرات ظهور الضمير في نهاية السنة الثانية، عندما يُبدأ باستخدام النواهي والأوامر على سلوكاته من قبل الوالدين، وعندما يحرّمان عليه بعضها ويجيزان بعضها الآخر، حيث يبدأ شيئاً فشيئاً باستدماج السلوكات المرغوبة وغير المرغوبة التي تمثل تصورات عامة عما يجب وعما لا يجب، وفي هذه المرحلة لا يتم فقط تعلم عدم إتيان السلوك غير المرغوب، بل السلوك المقبول المقابل له أيضاً، فلا يُنهى عن أن يكون عدوانياً تجاه الآخرين فقط، بل ويجب أن يكون عطوفاً متسامحاً محترماً لمصالح الآخرين وحقوقهم ومدافعاً عنها، أي إنه يبدأ بتعميم السلوكيات المحسوسة الخاصة بما يجب وما لا يجب لتشمل كل السلوكيات المرتبطة بالحلال والحرام في كافة مجالات تعامله مع الآخرين ومع ذاته أيضاً.
يعتمد نمو الأنا الأعلى بالضرورة على المعايير الأخلاقية للوالدين، وعلى طبيعة العلاقة بين الطفل ووالديه، فالوالدان ذوو المعايير الأخلاقية الناضجة وغير المتطرفة يساهمان بدرجة كبيرة بنمو أنا أعلى ناضج وغير متطرف أيضاً لدى ابنهما؛ فإذا تمتع الوالدان بعلاقة دافئة مع ابنهما فإنهما يسهلان عملية توحده بهما مما يجعله أكثر ميلاً للارتباط بهما بموافقة سلوكه لسلوكهما إلى الدرجة التي تجعله يشعر بالقلق إذا لم يتوافق سلوكه معهما؛ لأن ذلك يعني بشكل أو بآخر فقدان تأييدهما له، وبالتالي فقدان محبتهما التي يحرص كثيراً عليها، آخذين بالحساب أن الطفل في هذه المرحلة لا يعرف بالضرورة لماذا هذا السلوك صحيح وذاك خاطئ، إنه يتعلم فقط أن هذا السلوك يقال له صحيح وذاك يقال له خطأ.
من المهم الإشارة إلى أنه يمكن أن ينمو أنا أعلى غير ناضج أو غير سوي إذا لم يستطع الطفل التوحد بوالديه أو بأحدهما، أو إذا لم تكن لدى الوالدين معايير أخلاقية ناضجة ومقبولة أساساً من المجتمع؛ فالطفل قد يكون عارفاً بالمعايير المقبولة وغير المقبولة، ولكنه لا يسلك وفقاً لذلك؛ إذ يبدو أن محتوى الأنا الأعلى محقق في صحته ولكنه لا يقوم بوظيفته بشكل صحيح، وهذا حال كثير من الجانحين ومرتكبي الجرائم؛ إذ لديهم أنا أعلى جيد في محتواه يساعدهم على تمييز الخير من الشر والمقبول من غير المقبول من السلوك، ولكنه لا يقوم بوظيفته في منعهم من إتيان السلوك المنحرف، فنراهم يشعرون بالندم بعد إتيان السلوك غير المقبول، دون أن يكون لهذا الندم دوره في عدم تكرار حدوث هذا السلوك مرات أخرى..
إن نمو الأنا الأعلى نمواً سليماً لا يتحقق إن لم تتوافر للطفل الفرص المناسبة لتطبيق المعايير بشكل فعلي؛ إذ لا يكفي أن يقال له فقط أن يسلك كذا أو لا يسلك كذا، بل لا بد أن تتاح له الفرصة للتدرب على تطبيق هذه المعايير ليصار إلى ممارستها فيما بعد بشكل تلقائي يأخذ صفة العادة أو أسلوب الحياة.
الأخلاق والدين
من الواضح أن استخدام الأساليب السابق ذكرها في تنمية الأنا الأعلى أو الأخلاق له أسسه الجلية في القرآن الكريم، فكم من آية اعتمدت أسلوب الثواب والعقاب في حضها على ممارسة الأعمال الصالحة والابتعاد عما سواها، مستندة في ذلك إلى الآثار المترتبة عليها، ليست الآنية فقط، وإنما المؤجلة أيضاً، وإن كان التركيز يبدو على الأخيرة أكثر؛ الأمر الذي يعطي لفكرة يوم القيامة والحساب والجنة والنار أهميتها في ضبط السلوك وتوجيهه بعيداً عن المكاسب السريعة.
وكذلك كم من آية أكدت على أهمية القدوة الحسنة وأهمية ملاحظة قصص الأولين لأخذهم مثلاً يحتذى به، أو مثلاً يعتبر به أولو الألباب، بشكلٍ يمثلون لنا ضابطاً مهما لسلوكنا غير السوي.
من الواضح أيضاً أنه لا يوجد فصل واضح بين أي من هذه الأساليب في القرآن الكريم، بل هناك نوع من التكامل في استخدامها وتطبيقها، أياً كانت الأعمال التي يقوم بها الفرد على صعيده الذاتي الخاص، أو على صعيد المجتمع، أو العلاقة مع الله عز وجل، حتى ليخيل إلينا أن آيات القرآن الكريم ككل تأخذ بهذا التكامل في تنشئة الأفراد، وإن كانت في معظمها موجهة إلى الفرد البالغ العاقل المكلف المسؤول، مؤكدة أن اتباع هذا الأسلوب لا يقتصر على الأطفال، بل يشمل الراشدين أيضاً.
ولكن بالرغم من ذلك فإن ما يهمنا هنا هو السؤال عن مصدر الأخلاق المثلى، لنأخذ منه المعايير الخُلُقية اللازم غرسها في نفوس الناشئة، هل نأخذها من البيئة وما يضعه المنظرون أم نأخذها من الدين؟.
إن الإجابة عن هذه التساؤلات تبين لنا أن مصدر الأخلاق الأمثل لنا هو الدين، على اعتبار أن هناك ارتباطاً واضحاً بين الدين والأخلاق بمعناها الإنساني المتجرد عما هو سائد في مجتمع دون آخر. إن تغير الكثير من المفاهيم الأخلاقية عبر الزمان يؤكد أن الاعتماد فقط على المنظرين دون الأساس الديني لا يفي بالأغراض المرجوة من وضع المعايير الأخلاقية لضبط سلوك الأفراد؛ لأن التغير المستمر للمعايير يعطي انطباعاً بعدم ثبات الأخلاق ومن ثم عدم مصداقيتها، كما يعطي انطباعاً بتدخل العوامل الذاتية والمكاسب الشخصية للمنظرين والقائمين على اتخاذ القرارات بشأن الأفراد والمجتمع، بغض النظر عن الآثار المؤجلة المترتبة على ذلك، ولعلّ انتشار مظاهر الفساد، من قبيل البغاء والقتل والانحرافات الجنسية يعطي مؤشراً واضحاً على ذلك.
بالمقابل فإن اعتماد الدين كمصدر للمعايير الأخلاقية يعطي انطباعاً بثبات القيم والأخلاق وعدم تغايرها من مجتمع إلى آخر - لمجرد شيوعها أو عدم شيوعها في هذه المجتمعات - فهذه المعايير تبدو موضوعية لا ترتبط بمصالح شخص ما أو جهة معينة، ولعل هذا ما يؤكد ضرورة استمرار الأخذ بالمعايير الأخلاقية الواردة في الدين الإسلامي الحنيف.
ولكن وإن سلمنا بأن مصدر المعايير الأخلاقية الأمثل هو الدين، فهل نسلم بأننا كمجتمع عربي إسلامي نعتمد هذا المصدر أم أننا تركناه إلى مصادر أخرى؟.
إن الإجابة عن هذا التساؤل تشير بما لا يدعو للشك أننا لم نعتمد هذا المصدر في تنشئتنا لأبنائنا؛ فنحن نتردد بين الانقياد للدين وبين تقليد المعايير الأخلاقية الأجنبية عنا؛ مما يجعلنا في حالة صراع واضطراب غير واضحين، تقودنا في اتجاه غير محدد وفي طريق غير ثابت؛ ولعل السبب في ذلك هو عدم تغليب الدين وأسسه كنظام أخلاقي أولاً وسلوكي ومجتمعي ثانياً في مجتمعنا، إلى الدرجة التي أصبح فيها الالتزام ببعض المبادئ الأخلاقية الدينية قيداً لا بد من كسره، أو تخلفاً لابد من تجاوزه حتى نوصم بالتقدمية والمدنية!!.
من هنا يبدو أن إعادة تنشئة الأطفال أخلاقياً - وتربوياً بشكل عام - لا بد من أن ترتكز على القوانين الإلهية وليس على القوانين الوضعية، دون أن يساء فهم وتفسير وتأويل الآيات والأحكام بحسب أهوائنا ورغباتنا ومصالحنا؛ لأننا لو فعلنا ذلك فسنعود بشكل غير مباشر إلى اعتماد القوانين الوضعية ولكن بثوب إلهي.
ولعلّ هذه المهمة منوطة بالتربويين المنفتحين غير المتعصبين والمفكرين المتخصصين، آخذين بالحساب أسس التربية السليمة التي تتفق والطبيعة البشرية وما فطرت عليه.
المراجع والمصادر:
(*) مدرسة في قسم الصحة النفسية، كلية التربية - جامعة دمشق.
(1) تجربة التربية الإسلامية في ميزان البحث: د. محمد سعيد البوطي.
(2) علم نفس النمو: د. حامد زهران.
(3) دستور الأخلاق في القرآن: د. عبد الله زراد.
(4) الأطفال مرآة المجتمع: د. عماد الدين إسماعيل.
(5) جنح الأحداث: د. كمال أبو السعد.


 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه
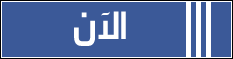
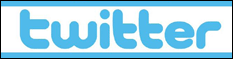








 العرض العادي
العرض العادي